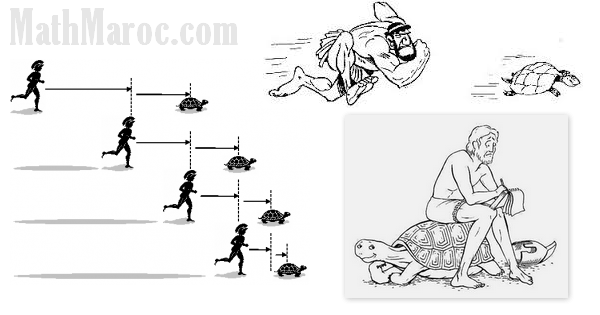ولتر ستيس؛ أرسطو. (اقتباسات من كتاب تاريخ الفلسفة اليونانية)
ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد.
Table
of Contents
الفصل الأول: فكرة الفلسفة اليونانية
بصورة عامة: أصول الفلسفة اليونانية: 13
المفكرون الأيونيون الآخرون: 36
الفصل الثالث: الفيثاغوريون: 37
ـ ملاحظات نقدية على الإيلية: 60
الفصل التاسع: السوفسطائيون: 97
الفصل الحادي عشر: أنصاف السقراطيين:
135
الفصل الثاني عشر: أفلاطون: 143
4ـ الفيزياء أو نظرية الوجود (مذهب
العالم ـ مذهب النفس الإنسانية) 177
7ـ تقييم نقدي لفلسفة أفلاطون: 198
1ـ الحياة والكتابات والطابع العام
لأعماله: 209
4ـ الفيزيقا أو فلسفة الطبيعة: 238
6ـ علم الجمال أو نظرية الفن: 265
7ـ تقدير نقدي لفلسفة أرسطو: 269
الفصل الرابع عشر: الطابع العام
للفلسفة بعد أرسطو: 275
الفصل الخامس عشر: الرواقيون: 279
الفصل السادس عشر: الأبيقوريون: 287
بين كتابات أفلاطون وكتابات أرسطو
لقد رأينا ـ في حالة أفلاطون ـ وقد امتدّ
نشاطُه الأدبي لفترة نصف قرن، وقد كانت فلسفته خلالها في حالة تطور دائم، أصبح من
المهم تتبّع هذا التطوّر حسب ترتيب محاوراته. والشيء نفسه ليس صحيحاً في حالة
أرسطو، فكل كتاباتِه، أو تلك التي وصلت إلينا، يبدو أنها كُتِبت خلال الثلاث عشرة
سنة [الأخيرة] من حياته وهو في أثينا بعد أن تجاوز الخمسين. لهذا فقد كان مذهبُه
مكتملاً وناضجاً وفي كامل تطوّره، ومسألة ترتيب كتاباتِه ليست بذات أهمية.
وعلى أية حال فإن نتيجة البحث النقدي تبيّن
أنه بدأ على الأرجح بالأعمال المختلفة عن المنطق، ويأتي بعد هذا العلمُ الفيزيائي،
ثم الكتب الأخلاقية السياسية، وأخيراً كتاب "الميتافيزيقا" الذي تُرِك
ناقصاً. (212)
[إضافة علوم جديدة]
عندما يكون هناك علم لم يكن له وجود من قبل
فإن خطته تتضمّن تأسيس علوم جديدة عندما تكون هناك ضرورة، ومن ثم أصبح مؤسس علمين
على الأقل، هما المنطق وعلم الحيوان. (213)
أرسطو وأفلاطون:
لقد قيل إن كلّ إنسان إما أنّ له عقلية من
النمط الأرسطي أو عقليةً من النمط الأفلاطوني.
ولمّا كان هذا القول يتضمّن أنّ أرسطو
وأفلاطون متعارضان، فإنه أقلّ من نصف الحقيقة. وما من فهم أصيل لأرسطو يستطيع أن
يعزز الرأي القائل إن مذهبه الفلسفي معارض تماماً لمذهب أفلاطون، بل الأفضل القول
إن أرسطو كان أعظم الأفلاطونيين، لأن مذهبه لا يزال مؤسساً على المثال، وهو محاولة
لتأسيس مثالية متحررة من نواقص مذهب أفلاطون. إن مذهبه في الواقع هو تطوّر
للأفلاطونية. (213)
الاختلافات [بين أرسطو
وأفلاطون] مصطنعةٌ إلى حدٍّ كبير، والاتفاق عميق للغاية.
والاختلافات كانت الأكثر
وضوحاً.. [لأنّ] أرسطو لم يترك فرصةً إلا وهاجم النظرية الأفلاطونية عن المثل،
ولقد كان باستمرار [مهتماً] بتأكيد الاختلاف بينه وبين أفلاطون، لكنه لم يقل شيئاً
عن الاتفاق. (214)
[يقول ستيس بأن فرنسيس بيكون انتقد أرسطو
لأنه لم يكن يعبأ بالوقائع، "بل ينظر المسألة "قبلياً" من
دماغه"، بينما الحقيقة أن هذا التوصيف ينطبق على السكولائيين وليس على أرسطو]
(215)
"وعلى أية حال، فمن الحق أن أرسطو،
حتى في مجال الحقائق، كان قبل كل القدماء متَّهماً بخطيئة إيراد استدلالات
"قبلية" عندما لا تكون هناك حاجةٌ إليها. ومن ثَمّ لم يكن يمتنع عن القول
بأن النجوم يجب أن تتحرك في دوائر لأن الدائرة هي الشكل الكامل.." (215)
كل فكرة يرغب [أرسطو] في التعبير عنها لها
مصطلحٌ محدّد. وإذا لم يكن هناك مصطلحٌ له استعمال مشترك يعبر عن الفكرة، فإن
أرسطو يصكّه، ومن ثَمّ فإنه واحدٌ من أكبر مبتدعي المصطلحات في العالم، ولقد اتخذ
أو اخترع عدداً هائلاً من المصطلحات، ولا نشتطّ إذا قلنا إنه يعدّ مؤسس اللغة
الفلسفية لأنه مخترع قاموسٍ من المصطلحات الفنّية. وكثيراً من المصطلحات التي لا
تزال تستخدم حتى اليوم للتعبير عن أكثر أفكار الإنسان تجريداً هي من اختراع أرسطو.
(216)
أرسطو والاستدلال
المنطقي.
من بين فرعيّ
الاستدلال الاستنباطي والاستقرائي، يعترف [أرسطو] بوضوح بالاستقراء، ومعظم
ملاحظاته على الاستقراء دقيقة ونفّاذة، لكنه لم يحصل [لم يجعل] من الاستقراء
علماً، وهو لم يصغ بوضوح القوانين الأساسية للتفكير الاستقرائي، فهذا لم يتمّ حتى
زمنٍ حديث نسبياً. ولهذا فإن اسمه يقترن بصفةٍ خالصة بالمنطق الاستنباطي الذي كان
هو مؤسّسَه. (216)
نقد
أرسطو لأفلاطون:
إن
نظرية أرسطو الميتافيزيقية تتطوّر على نحو طبيعي من جدله ضد نظرية أفلاطون في
المثل لأن مذهبَه هو بكل بساطة محاولةٌ للتغلب على أشكال القصور التي وجدها عند
أفلاطون. (218)
ورؤوس الموضوعات
الخاصة بهذا الجدال على النحو التالي:
1ـ إن أفكار
أفلاطون لا تشرح وجود الأشياء، فشرح السبب في أنّ العالم قائم هنا هو فوق كل
المشكلة الرئيسية للفلسفة، وقد فشلت نظرية أفلاطون في الاضطلاع بهذا. فإذا ضربنا مثلاً
وقلنا حتى وهي تعترف بأن فكرة البياض موجودة، فإننا لا نستطيع أن نبيّن كيف تنتج
الموضوعات البيضاء.
2ـ لم يشرح
أفلاطون علاقة المثل بالأشياء، فيقال لنا إن الأشياء هي "نسخ" من المُثل
و"تشارك" فيها، ولكن كيف نفهم هذه "المشاركة"؟
يقول أرسطو إن
أفلاطون باستخدامه مثل هذه العبارات لا يعبأ على نحو حقيقي بالعلاقة بل كل ما
يقوله هو مجرد "تشبيهات شعرية".
3ـ حتى لو أمكن
شرح وجود الأشياء بالمثل فإنه لا يمكن شرح حركتها. فلنفترض أن مثال البياض ينتج
الأشياء البيضاء وأن مثال الجمال ينتج الأشياء الجميلة وهكذا.. فإنه يتبقى أنه لما
كانت المثل نفسها ثابتة ولا متحركة فكذلك سيكون العالم الذي هو نسخة منها. وهكذا
سيكون الكون سكونياً على نحو مطلق مثل سفينة الشاعر "كولردج" المرسومة
على محيط مرسوم غير أن العالم ـ بالعكس ـ هو عالم تغير وحركة وحياة وصيرورة. إن
أفلاطون لم يبذل أية محاولة لشرح صيرورة الأشياء التي لا تنقطع وحتى لو كان مثال
البياض يفسر الأشياء البيضاء فإنه لا يزال هناك التساؤل عن السبب الذي يجعل هذه
الأشياء تظهر وتتطور وتتآكل وتكف عن الوجود، ولكي يمكن تفسير هذا لا بدّ أن يكون
هناك مبدأ ما للحركة في المُثل نفسه. غير أنه لا يوجد فهي ثابتة وبلا حياة.
..
5ـ من
المفروض في المُثل أنها لاحسّية، لكنها في الحقيقة حسّية.
لقد ظنّ
أفلاطون أنّ مبدأً حسّياً ما، يجب أن يخطر له لشرح عالم الحسّ. ولكن لمّا كان
عاجزاً عن إيجاد مثل هذا المبدأ فإن كل ما فعله هو تناول موضوعات الحسّ وتسميتها
لاحسّية. لكن في الحقيقة لا يوجد اختلاف بين الحصان ومثال الحصان، بين الإنسان
ومثال الإنسان، سوى التعبير العقيم الخالي من المعنى "في حدّ ذاته" أو
"بصفةٍ عامة"، يضاف إلى كل موضوع للحس يجعله شيئاً يبدو مختلفاً.
والمُثل ليست سوى موضوعاتٍ للحسّ "مؤقنمة" ويشبهها أرسطو بالآلهة
المشخّصة في الديانة الشعبية.
يقول
أرسطو: "وكما أنّ هذه الآلهة ليست سوى أناسٍ مؤلّهين فإن المُثل ليست سوى
أشياءِ الطبيعة وقد أضفي عليها الخلود".
لقد قيل إن الأشياء هي نسخ للمثل، ولكننا نجد في الواقع أن المثل ليست سوى
نسخ الأشياء. (219)
الشخص الثالث:
6ـ ثم يأتي بعد هذا جدل "الشخص الثالث" وقد سماه أرسطو على هذا
النحو من التصوير الذي يلجأ إليه لشرحه، إن المُثل مفترضة لكي تشرح ما هو عام
مشترك لعدة أشياء. وأينما يوجد عنصر عام مشترك يجب أن يكون هناك مثال من المُثل،
وهكذا هناك عنصر عام في كل الناس ولهذا هناك مثال للإنسان. ولكن هناك أيضاً عنصر
عام مشترك للإنسان الفرد ولمثل الإنسان. ولهذا يجب أن يوجد مثال آخر، هو
"الشخص الثالث" لكي يتم شرح هذا. وبين هذا المثال الجديد والإنسان الفرد
يجب أن يوجد مثال جديد آخر لشرح ما هو مشترك بينهما وهكذا دواليك إلى ما لانهاية.
(219)
[لست مع هذا النقد. المشترك بين هذا الشخص ومثال الإنسان هو مثال الإنسان
نفسه، وبالتالي ليس هناك تناسل للمثل إلى ما لانهاية]
7ـ غير أنّ أهمّ اعتراضات أرسطو على نظرية المُثل وذلك الذي يلخص كل
الاعتراضات الأخرى وفيه ذروة المقاصد والأغراض هو أ،ّ هذه النظرية تفترض أن المثل
هي ماهيات الأشياء. ومع هذا تضع هذه الماهيات خارج الأشياء نفسها. وإن ماهية شيء
ما يجب أن تكون فيه لا خارجه. غير أن أفلاطون يفصل المُثل عن الأشياء ويضع المثل
بعيداً في عالم غامض خاصٍ بها.
إن المثال باعتباره كلّياً لا يمكن أن يوجد إلا في الجزئي. من الممكن القول
إن الحقيقة في كل الجياد هي الجواد الكلّي، لكن الجواد الكلّي ليس شيئاً يوجد
بذاته وفي استقلال عن الجياد الفردية. ومن هنا ينتهي أفلاطون إلى لغو الكلام كما
لو كان يوجد ـ بجانب الجياد المفردة التي نعرفها ـ شيء مفرد آخر في موضوعٍ ما يسمى
الجواد بصفةٍ عامة، أو كما لو كان يوجد بجانب الأشياء البيضاء شيء اسمه البياض.
وهذا في الواقع ذروة التناقض الذاتي في نظرية المثل، فهي تبدأ بقولها إن
الكلّي هو الحقيقي والجزئي هو اللاحقيقي، لكنها تنتهي بالحط من شأن الكلي ليصل
مرةً أخرى إلى الجزئي. ويشبه هذا قولَنا إن خطأ أفلاطون يكمن أولاً (حقاً) في
رؤيته للجواد على أنه غير حقيقي ولكن يشرع "خطأ" في تصور الحقيقي على
أنه وجود. (220)
[بدائل ارسطو]:
ومن هذا
الاعتراض الأخير تنبع فلسفة أرسطو الخاصة، ومبدؤها الأساسي هو أن الكلّي هو حقاً
الحقيقة المطلقة لكنه كلّي لا يوجد إلا في الجزئي. (220)
إن الكلّي ليس جوهراً وكذلك الجزئي. إن كلاً منهما لا
يستطيع أن يوجد بمعزل عن الآخر. إن الجوهر يجب أن يكون مركّباً من الاثنين، إنه
يجب أن يكون الكلي في الجزئي. وهذا يعني أن ذلك وحده الذي يكون جوهراً هو الشيء
الجزئي، الذهب مثلاً بكل صفاته المحمولة عليه. (221)
العلّة الفاعلة
عند أرسطو:
والعلة الفاعلة
يحددها أرسطو دائماً على أنها علة الحركة. إنها الطاقة أو القوة المحركة المطلوبة
لإحداث التغيّر. ويجب أن نتذكر أن أرسطو لا يعني بالحركة مجرد تغير في المكان أو
نقلة في المكان بل يعني التغير من أي نوع. إن تغير ورقة من اللون الأخضر إلى اللون
الأصفر لهو تغير في الحركة بالمعنى الذي عنده بمثل ما إن سقوط حجر من الحجارة هو
حركة. إذاً فإن العلة الفاعلة هي علّة كل تغيّر. (223)
ومن المثل
المضروب أن ما يسبب البرونز لكي يكون تمثالاً أي ما ينتج هذا التغير هو النحات،
لهذا فإنه العلّة الفاعلة للتمثال.
والعلة الصورية يحددها أرسطو بأنها جوهر وماهية الشيء، والآن نجد أن ماهية الشيء واردة في
تعريفه، غير أن التعريف هو شرح المفهوم. ولهذا فإن العلة الصورية هي المفهوم أو هي
ـ كما يسميها أفلاطون ـ مثال الشيء. وهكذا تعاود مثل أفلاطون الظهور في أرسطو كعلل
صورية. والعلة الغائية هي النهاية، والغرض أو الهدف الذي تستهدفه الحركة. فعندما
يتم إنتاج التمثال فإنه غاية هذا النشاط، أي ما يستهدفه النحات هو التمثال المكتمل
نفسه. والعلة الغائية للشيء بصفة عامة هو الشيء ذاته، الوجود المكتمل للشيء.
إن العلم الحديث
لا ينكر حقيقة العلّتين الصورية والغاية. كل ما هنالك أنه يعتبرها خارج مجاله،
فليست وظيفة العلم [تحرّي] ما إذا كانت موجودتين أم لا. ومع تقدم المعرفة يحدث
التمايز وتقسيم العمل، ويعتبر العلم مجالَه هو العلل الآلية ويترك العلّتين
الصورية والغائية للفيلسوف لشرحهما. وهكذا نجد ـ على سبيل المثال ـ أنّ العلل
الصورية ليست موضع نظر العلم لأنها ليست بالمعنى الحديث عللاً على الإطلاق. (224)
[منهجية ما زالت صالحة]
لم تكن من عادة أرسطو أن يعرض لنظرياته كما لو كانت
شيئاً جديداً تماماً تصدر لأول مرّةٍ من عقله. فهو في هجومه على أية مشكلة كانت
عادتُه أن يبدأ بالتيار السائد والآراء السابقة لينقدها ويطرح ما لا قيمة له لكي
يستبقي خلاصة الحقيقة ويضيف إليها اقتراحاتِه وأفكارَه الأصلية. (225)
[أرسطو يستنبط العلل من تاريخ الفلسفة]
[الأيونيون بحثوا في العلة المادية].
لكن مع تقدم الفكر وظهور فلاسفة آخرون على الساحة.. فقد
تبيّن ضرورة وجود علّة ثانية لتفسير الحركة وصيرورة الأشياء. غير أنّ المادة
نفسَها لا تنتِج حركتَها، فالخشب ليس علّة تحوّله إلى سرير... ومن ثّمّ نشأت فكرة العلة الفاعلة.
إن الإيليين لم يتبيّنواه لأنهم أنكروا الحركة، ولهذا
فبالنسبة لهم لا يمكن افتراض علّة للحركة. ويرى أرسطو أن بارمنيدس مع هذا فقد
تأرجح حول هذه النقطة وأباح على شكلٍ غامض وجود علّة ثانية عيّنها على أنها الحار
والبارد... وقد افترض الفلاسفة الآخرون على نحوٍ واضح وجود علّة فاعلة لأنهم ظنوا
أن عنصراً واحداً ـ النار على سبيل المثال ـ أكثر فاعلية من العناصر الأخرى، أي
إنه أكثر إنتاجاً للحركة. ومن المؤكد أن أنبيدوكليس قد قال بفكرة العلة الفاعلة
لأنه عيّن القوى المحرّكة بأنها التناغم والتنافر، الحب والكراهية. كما استخدم
أنكساغوراس أيضاً العقل على أنه قوةٌ محرّكة.
وربما أدرك العللَ الصورية أيضاً الفيثاغوريون، فالأعداد
أشكالٌ أو صور. غير أنهم أحطوا على نحو مباشر من العلة الصورية لتصل إلى مستوى
العلة المادية بإعلانهم أن العدد هو الخامة أو المادة التي تصنع منها الأشياء.
وكان أفلاطون وحده هو الذي بيّن بوضوح ضرورة العلّة
الصورية، لأن العلل الصورية ـ كما رأينا ـ هي نفسها مثُل أفلاطون. غير أنّ فلسفة
أفلاطون لا تتضمّن سوى علّتين من العلل الأربع، هما العلة المادية والعلة الصورية،
لأن أفلاطون جعل الأشياء جميعاً من المادة والمُثُل. ولمّا كانت المُثُل ليس فيها
مبدأ الحركة، فإن مذهب أفلاطون لا يحتوي على علّةٍ فاعلة. أما بالنسبة للعلل
الغائية فإنّ لدى أفلاطون فكرةً غامضة هي أنّ كل شيء من أجل "الخير"،
لكنه لم يستخدم هذا التصور ولم يطوّره.
ولقد أدرجَ
أنكساغوراس العلل الغائية في الفلسفة، فإن مذهبه عن العقل المشكل للعالم يفترض أن
يفسر التصميم والغرض اللذين يعرضهما الكون، ولكن مع تطور مذهبه نسي هذا الأمر
وستخدم العقل لا لشيء سوى كجانبٍ من الآلية لتفسير الحركة، وهكذا تركه يهبط إلى
شيء لا يزيد شيئاً عن العلة الفاعلة. (226)
الخطوة التالية
في ميتافيزيقا أرسطو هي رد هذه المبادئ الأربعة إلى مبدأين سمّاهما الهيولي
والصورة. ويحدث هذا التنقيص في عدد العلل عن طريق إظهار العلّة الصورية والعلة
الفاعلة والعلة الغائية كلها تنصهر في تصوّر وحيد للصورة. (226)
أولاً: نجد أن
العلة الصورية والعلة الغائية شيءٌ واحد وذلك لأن العلة الصورية هي الماهية،
المفهوم، فكرة الشيء. والآن فإن العلّة الغائية أو النهائية هي ببساطة تحقق فكرة
الشيء في الواقع. إن ما يهدف إليه الشيء هو التعبير المحدد لصورته، إنه يستهدف
صورته. وهكذا فإن الغاية، العلة الغائية هي نفس العلة الصورية.
ثانياً: فإن
العلة الفاعلة هي نفسها العلة الغائية لأن العلّة الفاعلة هي سبب الصيرورة والعلة
الغائية هي نهاية الصيرورة، إنها ما يصير. وفي رأي أرسطو إن ما يسبب الصيرورة هو
ذلك الذي تستهدفه في النهاية فحسب. (227)
الصورة والشكل عند أرسطو
إن ما يصبح هو الهيولي، وما يصبح عليه هو الصورة. إن الخشب هيولي إذا نُظِر
إليه من ناحية علاقته بالسرير، لأنه يصبح سريراً، غير أن الخشب هو الصورة إذا
نُظِر إليه في علاقته بالنبات النامي لأنه هو الذي يصبح عليه النباتُ. إن شجرة
البلوط هي صورةُ جوزةِ البلوط، لكنها هي هيولي الأثاث المصنوع من البلّوط. إن
الهيولي والصورة مصطلحان نسبيان وهما يظهران أيضاً أن الصورة ليست مجرد شكل، لأن
ما هو صورةٌ في جانب هو هيولي في جانبٍ آخر، لكن الشكل لا يمكن أن يكون أيّ شيءٍ
إلا أن يكون شكلاً. (229)
ومما لا شكّ فيه أن الشكل جزءٌ من الصورة، لأن الصورة تتضمّن في الحقيقة كل
صفات الشيء، لكن الشكل هو جزءٌ غير مهم في الصورة، لأن الصورة تتضمن التنظيم
وعلاقة الجزء بالجزء وخضوع كل الأجزاء للشكل. إن الصورة محصلة العلاقات الداخلية
والخارجية، إنها هي الإطار المثالي ـ إذا جاز لنا مثل هذا القول ـ والذي فيه ينتظم
الشيء. وتتضمّن الصورة أيضاً الوظيفة، ووظيفة الشيء هو مجرد ما يكون الشيء من
أجله، وهذا مماثل لغايته أو علته الغائية. من ثّمّ فإنّ الوظيفة واردة في الصورة،
فمثلاً وظيفة اليد هي قوّتها على الإمساك، وهذه الوظيفة جزء من صورتها، ولهذا إذا
فقدت وظيفتها ببترها فإنها تفقد بالمثل صورتَها، وحتى اليد الميتة ـ بطبيعة الحال
ـ لها صورة ما، لأن كل شيءٍ جزئي هو مركب من الهيولي والصورة؛ لكن اليد الميتة قد
فقدت أهم جزء في صورتها وهي بالنسبة لليد الحية مجرد هيولي، وإن كانت بالنسبة للحم
والعظم الذي تتكوّن منه لا تزال صورة. الصورة ـ بوضوح إذاً ـ ليست مجرد شكل لأن
اليد المبتورة لا تفقد شكلها ـ والصورة تتضمن كل صفات الشيء، والهيولي هي ما [ليس]
له صفات، لأن الصفات كلها كليات. إن قطعة الذهب صفراء، وهذا يعني ببساطة أنها
تشترك في الصفرة مع قطع الذهب الأخرى والأشياء الصفراء الأخرى. والقول عن الشيء
إنه يتصف بصفةٍ ما يعني وصفه ضمن فئة وما تشترك فيه الفئة هو شيء كلّي، والشيء
بدون صفات لا يمكن أن يوجد كما إن الصفات لا يمكن أن توجد بدون الشيء وهذا مماثل
لقولنا إن الصورة والهيولي لا يمكن أن توجدا منفصلتين.
الهيولي إذاً هلامية تماماً، إننها (البنية) التي تضم كل شيء، وهي لا تضم
في ذاتها أية صفة، إنها لا صفاتٍ لها، إنها لا تعيّن بدون صفة. وما يعطي الشيء
تعيّنا وطابعاً وصفةً وما يجعله هذا الشيء أو ذاك هو صورته. (230)
وبالتالي لا
توجد فروق في الهيولي فالشيء لا يمكن أن يختلف عن غيره إلا بأن تكون له صفات
مختلفة. ولمّا كانت الهيولي بلا صفات فليس فيها فروق وهذا يبيّن في ذاته أن الفكرة
الأرسطية عن الهيولي ليست مثل فكرتنا عن الجوهر الفيزيائي. فحسب استخدامنا الحديث
يختلف نوع المادة من نوع إلى آخر، فيختلف النحاس عن الحديد، لكن هذا الفرق هو فرق
صفة. والصفات كلها عند أرسطو جزءٌ من الصورة ومن ثمّ فعنده إن اختلاف النحاس عن
الحديد ليس مسألة اختلاف في الهيولي، بل اختلاف في الصورة. وعلى هذا يمكن للهيولي
أن تصبح أيّ شيءٍ حسب الصورة المطبوعة عليها، إن الهيولي هي إمكانية كل شيء وإن
كانت هي في الواقع ليست شيئاً، وهي لا تصبح شيئاً إلا بإحرازها للصورة، وهذا يؤدي
مباشرةً إلى أكبر تناقض أرسطي هام بين القوة والفعل. القوة هي نفسها الهيولي
والفعل هو الصورة، فالهيولي هي كل شيء بالإمكانية، فهي قد تصبح كل شيء، وهي بالفعل
ليست شيئاً، إنها مجرد إمكانية أو قدرة على أن تصبح شيئاً، ولكن ما يعطي الهيولي
تعيّنا على أنها هذا أو ذلك وما يجعلها شيئاً فعلياً هو الصورة وهكذا فإن واقعية
الشيء هي بكل بساطة صورته. (231)..
[لكن هذا يخالف
ما قاله ستيس سابقاً من أن الخشب هو صورة إذا نظر إليه في علاقته بالنبات هيولي
إذا نظر إليه في علاقته بالسرير. فالهيولي في مراحله الوسيطة لا يمكن أن يكون بغير
صفات..]
عندما نقول إن الهيولي هي إمكانية ما سيصبح، فإنه يتضمّن أنّ ما ستصبح عليه
ماثلٌ من قبلُ فيها مثالياً وبالإمكان، وإن لم يكن فعلياً. لهذا فإن الغاية ماثلةٌ
من قبلُ في البداية.
إن شجرة البلّوط قائمةٌ في جوزة البلّوط على نحوٍ مثاليٍّ وإلا فإن شجرة
البلّوط [لن] تصدر عن جوزة البلّوط إطلاقاً. ولمّا كانت كل صيرورة هي نحو غايةٍ
ولا تحدثُ إلا من أجل غاية، فإن الغاية هي المبدأ العامل والعلة الحقيقية
للصيرورة. الحركة لا تنتج بقورة عرضيةٍ آليةٍ بالدفع من الخلف، بل بقوة جذب مثالية
تجذب الشيء نحو غايته كما تنجذب قطعة الحديد للمغناطيس.
إن الغاية هي التي تمارس هذه القوة ولهذا فإن الغاية يجب أن تكون ماثلةً في
البداية لأنها لو لم تكن ماثلةً فلن تستطيع أن تمارس أية قوة. وهي ليست ماثلةً
فحسب في البداية، إنها خارجية عنها أيضاً لأن
الغاية هي علة الحركة، والعلّة من الناحية المنطقية أسبق من نتيجتها.
وهكذا نجد أن الغاية أو مبدأ الصورة هو الأول المطلق في الفكرة والواقع،
وإن تكن الأخيرة في الزمن. فإذا سألنا ـ إذاً ـ ما هي تلك الحقيقة المطلقة عند
أرسطو، ما هو المبدأ الأول الذي يصدر عنه الكون كله فإن الجواب هو: الغاية، مبدأ
الصورة، ولمّا كانت الصورة هي الشكل، المثال، فإننا نتبيّن أن هذه الأطروحة
الأساسية هي نفسها أطروحة أفلاطون، إنها أطروحة كل مثالية وهي أن الفكري الكلّي،
العقل هو الموجود المطلق، أساس العالم. ولا يختلف عن أفلاطون إلا في إنكار أنّ
الصورة لها وجود بمعزل عن الهيولي التي تعرض الصورةُ نفسَها فيها. (232)
لمّا كانت
السيرورة في العالم هي ارتقاء مستمرّ للهيولي إلى الصور الأرقى..، فيترتّب على هذا
أن الكون يعرض سلّماً مستمرّاً للوجود. وما هو أرقى في السلم حيث تسود الصورة فإن
الأدنى هو ما تفوّق الهيوليُّ فيه الصورةَ، وفي أسفل السلّم ستكون هناك الهيولي
الهلامية المطلقة وفي قمّته الصور اللامادية المطلقة. وعلى أية حال، فإن هذين
الطرفين تجريدان، فلا أحدَ منهما يوجد لأن الهيولي والصورة لا يمكن أن تنفصلا. وما
يوجد يأتي في موضع ما بين الاثنين، ومن ثَمّ يعرض الكون عملية من التدريجات
المستمرة. وتحدث الحركة والتغيّر بجهدٍ للانتقال من الأدنى إلى الأرقى تحت تأثير
القوة الجاذبة للغاية [للعلّة الغائية].
[المحرك الذي لا
يتحرك]
وما يأتي في
قمّة السلّم، الصورة المطلقة، يسميه أرسطو الله. وتعريفات صفة الله تترتّب على هذا
الوضع بالطبع. أولاً، لما كانت الصورة هي الفعل، فإن الله وحدَه هو الواقعي على
نحوٍ مطلق، فهو وحده الحقيقي، وكل الموجودات غير واقعية بشكلٍ ما. إن الأرقى في
السلم هو الكثر واقعية لأنه يمتلك المزيد من الصورة. وسلم الوجود هو أيضاً سلم
للواقع، وهو يتأرجح من خلال تدريجات لا متناهية من الحقيقي المطلق وهو الله إلى
اللاحقيقي المطلق وهو الهيولي الهلامية.
ثانياً، لمّا
كان مبدأ الصورة يحتوي على العلل الصورية والغائية والفاعلة، فإن الله هو كل هذه
العلل. ولمّا كان الله هو العلة الصورية فإنه هو المثال، إنه فكر، علة ـ ولمّا كان
الله هو العلّة الغائية فإنه الغاية المطلقة، إنه ذلك الذي تسعى إليه كل
الموجودات، وكل موجود له دون شك غايته في ذاته ولكن لمّا كان الله هو الغاية
المطلقة، فإنه يشتمل على كل الغايات الأدنى. ولمّا كانت غاية كل شيء هي الكمال
المتكامل للشيء فإن الله باعتباره الغاية المطلقة هو الكمال المطلق. وأخيراً، لمّا
كان الله هو العلة الفاعلة فإنه العلة المطلقة للحركة والصيرورة. إنه المحرك
الأول، وعلى هذا فإن الله نفسه غير متحرك. وكون المحرّك الأول غير متحرك نتيجة
ضرورية لتصور أرسطو له كغاية وكصورة، فالحركة هي انتقال الشيء نحو غايته، والغاية
المطلقة لا يمكن أن تكون لها غاية وراءها ومن ثم لا يمكن أن تتحرك.
وبالمثل، الحركة
هي انتقال الهيولي إلى الصورة. والصورة المطلقة لا يمكن أن تنتقل إلى صورة أرقى
ومن ثم فهي غير متحركة، غير أن الحجة التي يستخدمها أرسطو نفسه كثيراً لتأسيس
حركية المحرك الأول هي أنه عالم بتصوره غير متحرك فلن تظهر أية علة للحركة، إن
الشيء المتحرك قد يتحرك بشيء آخر، وحركة هذا الشيء الأخير يتطلب علةً أخرى، فإذا
كانت هذه العلة الجديدة هي نفسها متحركة فإننا يجب أن نبحث عنه لحركتها، وإذا
استمرت هذه العملية إلى الأبد فلن يتم تفسير الحركة ولا تظهر العلة الحقيقية، لهذا
فإن العلة الحقيقية والمطلقة يجب، لهذا، ألا تكون متحركة. (235)
الله لا يكون
المحرك الأول إلا بصفته كغاية نهائية.
الله ليس علّةً أولى بالمعنى الخاص بنا: أي ليس علّةً آليةً أولى تكون قبل
العالم وتخلقه. إنه علّةٌ غائيةٌ تعمل من الغاية، ولكنه على هذا النحو هو سابق
منطقياً على كل بداية وكذلك المحرك الأول. ولما كان الكون ليست له بداية في الزمن، فإنه ليست له نهاية في الزمن.،
وسيستمر إلى الأبد. وغايته الصورة المطلقة، ولكن لا يمكن التوصل إليها، لأنها لو
كانت هكذا فهذا يعني أن الصورة المطلقة توجد، بينما نحن رأينا أن الصورة لا يمكن
أن توجد بمعزل عن الهيولي.
[الله عند أرسطو]
إن الله فكر. ولكنه فكرٌ عن أيّ شيء؟
باعتباره صورةً مطلقة، ليس هو صورةُ الهيولي، بل صورة الصورة. وهيولاه ـ
إذا جاز لنا القول ـ صورة.
والصورة باعتبارها الكل هي الفكر، وهذا يعطينا تعريف أرسطو الشهير لله على
أنه "فكر الفكر". إنه لا يفكر إلا في ذاته، إنه ذاتُ وموضوعُ تفكيره.
(235)
رأي لـ ستيس:
ما أخلص إليه هو
أنه لم يكن قصد أرسطو أن ما يسميه الله يجب اعتباره شخصاً، فالله ليس فكراً
ذاتياً. إنه ليس فكراً موجوداً في عقل، بل هو فكر موضوعي حقيقي في ذاته بمعزل عن
أيّ عقل يفكر فيه مثل أفلاطون، غير أن خطأ أفلاطون هو افتراض أنه لمّا كان الفكر
حقيقياً وموضوعياً فيجب أن يوجد ولقد تجنب أرسطو هذا الخطأ، والفكر المطلق هو
الحقيقي بإطلاق، لكنه لا يوجد. وبمفهوم الله تختتم ميتافيزيقا أرسطو.
الفيزياء وفلسفة
الطبيعة:
[عقول]
.. إن أيّة
فلسفة حقيقية بالرغم من إقرارها بالتفرقة بين الحس والعقل، يجب مع هذا أن تجد
موضوعاً لوحدتها، ويجب أن تظهر أن الحس ليس سوى شكلٍ أدنى للعقل، ولقد استوعب
أرسطو هذه الفكرة تماماً ولم يوضح فحسب أن الحس هو العقل، بل قال حتى إن أوجُهَ
نشاط المادة غير العضوية مثل الجاذبية هي عقل.
والمحصلة أن الطبيعة
رغم أنها تعمل من خلال العقل ليست واعية بهذا، وهي تفعل هذا على نحوٍ غريزي
وتلقائي، وهي أشبه بالفنان المبدع الذي يشكل موضوعاتِه الجميلةَ بالغريزة أو كما
نقول بالإلهام، دون أن يطرح أمام عقله الغاية التي يجب تحقيقُها أو القواعدَ التي
يجب اتّباعُها لكي تتحقق. (239)
في عملية الطبيعة أو سيرورتها، الصورة دائماً هي التي ترغم الهيولي.
والهيولي هي التي تتقهقر وتعترض. وحركة العالم الكلّية هي جهد الصورة لتشكيل
الهيولي، ولكن، لمّا كانت للهيولي في ذاتها قوة [مقاومة] فإن هذا الجهد لا ينجح
دائماً. وهذا هو السبب الذي يجعل الصورة لا تستطيع أن توجد بدون الهيولي، لأنها لا
تستطيع أن تقهر تماماً النشاط المعرقل للهيولي، ومن ثّمّ لا يمكن للهيولي أن تذوب
تماماً في الصورة. وهذا يفسّر أيضاً ما يحدث عرَضاً في الطبيعة من شواذ ووحوش
ومشوّهين، فهنا نجد أنّ الصورة قد فشلت في أن تذلّل الهيولي، لقد فشلت الطبيعة في
تحقيق غايتها. (240)
[الطبيعي وغير الطبيعي]
العلم يجب أن يدرس ما هو طبيعي وعادي لا ما هو شاذ ومشوّه.. وأرسطو مغرم
باستخدامه الدائم لكلمتيّ "طبيعي" و "غير طبيعي"، لكنه
يستخدمهما دائماً بهذا المعنى الخاص. ما هو طبيعي هو ما يحقق غايته حيث تنجح
الصورة في السيطرة على الهيولي.
[بين أرسطو
وداروِن]
.. إن الصورة
الأدنى تنتقل في الوقت المناسب إلى الصورة الأرقى، لكن هذا ليس إلا اكتشافاً في
الأزمنة الحديثة، ومثل هذا التصور كان مستحيلاً بالنسبة لأرسطو، فعنده إن الأجناس
والأنواع خالدة ليس لها بداية أو نهاية. الناس الأفراد يولدون ويموتون، لكن النوع
الإنساني لا يموت أبداً وهو يظل موجوداً دائماً على الأرض، والشيء نفسه حقيقي
بالنسبة للنباتات والحيوانات. (241)
[كلمة
"عضوي"]
.. إن التفرقة
الأولى التي تقدمها الطبيعة لنا هي بين ما هو عضوي وما هو غير عضوي. ولقد كان
أرسطو هو مكتشف فكرة العضوية كما كان مخترع الكلمة. (242)
[بين اللاعضوي
والعضوي]
إذا كانت
الهيولي اللاعضوية هي ما له غايته خارجه [أي يخضع لقوانين الطبيعة فقط كالجاذبية]،
فإن الهيولي العضوية هي ما له غايةٌ في داخله.. إنها مبدأ تطوري ذاتي داخلي، ومن
ثم فإن وظيفتها ليست سوى تحقق أو تكشف هذه الغاية الداخلية. فبينما لا نجد للهيولي
اللاعضوية نشاطاً سوى الحركة المكانية، فإن الهيولي العضوية نشاطها هو النمو.. من
الداخل.(243)
النفس عند أرسطو
النفس هي تنظيم أو صورة الجسم ببساطة. وكما أنّ الصورة لا تنفصل عن
الهيولي، فإن النفس لا تستطيع أن توجد بدون الجسم، إنها وظيفة الجسم. وهي بالنسبة
للجسم بمثابة البصر للعين. وبهذا المعنى نفسه يرفض أرسطو مذهب الفيثاغوريين
وأفلاطون القائل إن النفس تتناسخ في أجسام جديدة وخاصةً في أجسام الحيوانات،
فوظيفة الشيء لا يمكن أن تصبح وظيفةَ شيء آخر. (247)
.. وهو يستبعد أيّ مذهب للخلود لأن الوظيفة تتلاشى مع الشيء.
ونستطيع أن
نلاحظ.. أن نظرية أرسطو في النفس لا تشكل تقدماً كبيراً بالنسبة لنظرية أفلاطون
فحسب، بل هي تشكل تقدماً كبيراً أيضاً بالنسبة للتفكير الشائع في الوقت الحالي،
فالتصور العادي للنفس الذي هو عين تصوّر أفلاطون، هو أن النفس شيء. ولمّا كانت
شيئاً، فإنه يمكن أن توضع في جسم وتؤخذ منه كما يمكن صب النبيذ في قنينة وسكبه
منها. والرابطة بين الجسم والنفس هي رابطة آلية خلصة، فهما لا يرتبطان معاً برابطة
ضرورية، بل بالقوّة [أي كاحتمال ممكن]. وهما بطبعهما لا ترابط بينهما ويصعب تبيّن
السبب الذي يجعل النفس تدخل في جسم أصلاً إذا كانت في طبيعتها شيئاً منفصلاً
تماماً.
.. النفس ليست
شيئاً على الإطلاق، إنها وظيفة. (248)
أما العقل
الفعّال فهو خالد ولا يفنى، وهو ليست له بداية وليست له نهاية، وهو يأتي للجسم من
الخارج ويفارقه عند الموت. ولمّا كان الله هو العقل المطلق، فإن عقل الإنسان يصدر
عن الله ويعود إليه بعد أن يكف الجسم عن أداء وظيفته.
إن كل الملكات
الدنيا تتلاشى مع الموت بما في ذلك الذاكرة.
.. فإذا فنيت
الذاكرة فإنه لن تكون هناك حياة شخصية.
إذا كان أرسطو يعتقد
حقاً أن العقل شيء يدخل في الجسم ويخرج منه وهو شيء استثنائي لمذهبه العام في
النفس، فكل ما يمكن قوله هو أنه يحدث انقطاعاً فجائياً في السلّم الفلسفي، فهو بعد
أن روّج لمثل هذه النظرية المتقدمة يرتد إلى الرأي الفج الذي عند أفلاطون. ولمّا
كان هذا غير محتمل فإن التفسير الأكثر ترجيحاً هو أنه يتحدث هنا بطريقة تشبيهية
بالكناية وربما بهدف استرضاء المتدينين وتجنب أي اضطراب عنيف للإيمان العالم
الشعبي. (248)
فإذا كان الأمر
هكذا فإن عباراته القائلة إن العقل الفعّال خالد ويأتي من الله ويعود إلى الله، تعني
بكل بساطة أن عقل العالم خالد وأن عقل الإنسان هو تحقق هذا العقل الخالد وهو بهذا
المعنى "يأتي من الله" ويعود إليه. (249)
[عند أرسطو] المطلق هو العقل، الصورة اللامادية. وكل شيءٍ في العالم هو في
جوهره عقل. وإذا أردنا أن نعرف الطبيعة الجوهرية حتى لهذه الأرض الباردة، فإن
الجواب هو أنها عقل، وإن كان هذا الرأي لم يقله أرسطو..
إن العقل لا يستطيع أن يعبر عن ذاته في الكائنات الأدنى [من الإنسان] إلا
كإحساس (حيوانات) أو كتغذية (النباتات) أو كجاذبية (الهيولي غير العضوية).
.. إن نظرية أرسطو من أكثر التصورات قيمةً في الفلسفة [ويتّضح ذلك أكثر]
إذا قارنّاها بالنظريات العلمية المحدثة عن التطوّر، وثانياً بجوانب معيّنة من
وحدة الوجود الهندوكية. (252)
[الغائية وفلسفة
الطبيعة]
.. إذا كان يجب
أن تكون لدينا فلسفة للتطور يجب أن تكون غائية.
وإذا لم تكن
الطبيعة تتقدم نحو غاية، فلن يكون هناك شيءٌ أقرب أو أبعد، لا يوجد شيءٌ اسمه أرقى
أو أدنى، لا يوجد تطوّر. فما هي الغاية إذاً؟
يقول أرسطو إنها
تَحقّق العقل. إن الوجود الأدنى هو العقل الخالد، ولكن هذا ليس موجوداً بل يجب أن
يأتي إلى الوجود. إنه يعلن نفسه بغموض على أنه جاذبية، لكن هذا أبعد ما يكون عن
غايته التي هي وجود العقل كعقل في العالم، وهو يزداد قرباً في النباتات
والحيوانات، وهو يصل على نحو تقريبي في الإنسان، لأن الإنسان هو العقل الموجود
ولكن لا معنى في الكون للتوقف عندما يصل إلى غايته. (255)
.. الفكرة الرئيسية في وحدة الوجود هي أن كل شيء هو الله. فبرودة الأرض
إلهية لأنها تجلٍّ للرب. وهذه الفكرة طيبة وهي في الحقيقة جوهرية للفلسفة. ونحن
نجد فيها أرسطو نفسه حيث إن العالم كله بالنسبة له هو تحقق العقل، والعقل هو الله.
(255)
الأخلاق عند
أرسطو:
إن الخير لكل
موجود يجب أن يكون الأداء الشديد لوظيفتها الخاصة.
ولا يقوم خير
الإنسان في لذة الحواس، فالإحساس هو الوظيفة النوعية للحيوانات لا للإنسان، أما
وظيفة الإنسان النوعية فهي العقل، ومن ثَمّ فإن نشاط العقل هو الخير الأقصى، الخير
[الخاص بالإنسان]. وتقوم الأخلاقيات في حياة العقل. ولكن المقصود بهذه الدقة هو
التالي:
ليس الإنسان
حيواناً عقلياً فحسب، فلمّا كان موجوداً أرقى فإنه يحتوي بداخله على ملَكات
الموجودات الأدنى أيضاً. فهو مثل النباتات غاذٍ، ومثل الحيوانات حساس، فالانفعالات
والشهوات جزء عضويّ في طبيعته. ومن ثم فإن الفضيلة نوعان: الفضائل العليا توجد في
حياة العقل وحياة الفكر والفلسفة، وهذه الفضائل العقلية يسميها أرسطو الفضائل
العقلية.
ثانياً، الفضائل
الأخلاقية الملائمة تقوم في إخضاع الانفعالات والشهوات لسيطرة العقل. والفضائل
العقلية هي الأعلى حيث تعمل الوظيفة النوعية للإنسان، ولأن الإنسان العاقل يشبه
الله الذي حياتُه هي حياة الفكر الخالص. (258)
تطرفان:
هناك تطرّفان يجب تجنّبهما. التطرّف الأول هو محاولة استئصال الانفعالات، والتطرّف الأخر هو السماح لها بأن تصل إلى الفوضى. (260)
..
وبنفس الطريقة
لا يقصد أرسطو أن البطل الكوميدي هو بالضرورة إنسان وغد، بل هو على الجملة مخلوق
تعس بلا أهمية، وقد تكون له جدارته ولكن هناك شيء وضيع وحقير فيه يجعلنا نضحك.
(269)
أرسطو وهيغل
يقول ولتر ستيس:
يستحق أرسطو الجدارة في أنه قدّم الفلسفة الوحيدة في التطور التي رآها العالم، مع
استثناء فلسفة التطور عند هيغل، ولم يتمكن هيغل من أن يجد نظريةً أكثر جدادة [ربما
جدارةً] في التطور إلا بعد أن سار إلى حدٍّ كبير على آثار أرسطو، وربما كان هذا
أكثر إسهامات أرسطو في الفكر أصالة. (270)
إن الصيرورة عند
[هيراقليطس وأتباعه] لم تكن إلا تغيراً لا معنى له، ولم تكن تطوّراً، وسيرورةُ
العالم كانت تياراً لا نهاية له من الأحداث العقيمة التي هي بلا هدف، ليست سوى
"قصةٍ يرويها أبله وهي مليئةٌ بالصخب والعنف ولا تعني شيئاً" (شكسبير).
ولم يسأل أرسطو نفسه فحسب كيف تكون الصيرورة ممكنة، لقد بيّن أن للصيرورة معنىً
وأنها تعني شيئاً وأن سيرورة العالم هي تطوّر منظم عقلياً نحو غاية معقولة.
الفهرس